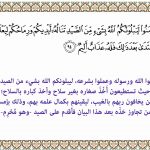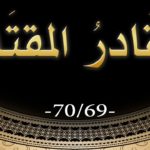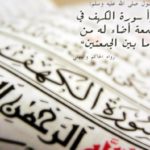صحار بن العباس العبدي
هو أبو عبد الرحمن صُحار بن عياش (العباس) ابن شُراحيل بن منقذ العَبْديّ نسبة إلى عبد القيس، من بني مرة من عمان.
ذكرته جملة مصادر، وتباينت في أمره وحقيقة انتماءه.
وهو أحد الصحابة الذين وفدوا على النبي -صَلَّى اللَّه عليهِ وسَلَّم- عامَ الفتح مع جماعة قدموا المدينة، فخرج النّبي -صَلَّى اللَّه عليهِ وسَلَّم- في الليلة التي قدموا في صُبْحها، فقال: “لَيَأْتِيَنَّ رَكْبٌ مِنْ قبلِ المَشْرِقِ، وَلَمْ يُكْرَهُوا عَلَى الإِسْلاَمِ، لصَاحِبِهِمْ عَلاَمَةٌ”.
فقدموا فقال -صَلَّى اللَّه عليهِ وسَلَّم-: “اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعبد القَيْسِ”.
شارك في الفتوحات الإسلاميَّة، ولَمَّا فتح الحكم بن العاص مكران، أرسل بالأخماس مع صحار العبدي إلى الخليفة عمر بن الخطاب، فسأله عن مكران، فقال: “هي أرض سهلها جبل، وماؤها وشل، وثمرها دقل وعدوها بطل، وخيرها مكيل، وشرها طويل، والكثير بها قليل …” فقال له عمر: “أسجاع أنت أم مخبر”.
قال: لا بل مخبر.
فقال: “واللَّه لا يغزوها جيش لي أبدًا …”.
روى عن النبي -صَلَّى اللَّه عليهِ وسَلَّم- حديثين أو ثلاثة وممن روى عنه ابنه جعفر، وله من الكتب كتاب الأمثال، لذلك فهو يُعَدُّ أول من صنف في الأدب من الصحابة في صدر الإسلام، ومن الأخبار التي تدل على بلاغته سؤال معاوية بن أبي سفيان له: “ما هذه البلاغة التي فيكم؟ قال: شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على السنتنا.
فقال له رجل من عرض القوم: يا أمير المؤمنين، هؤلاء بالبسر والرطب، أبصر منهم بالخطب.
فقال له صحار: أجل واللَّه، إنَّا لنعلم إن الريح لتلقحه، وإن البرد ليعقده، وإن القمر ليصبغه، وإن الحر لينضجه.
و سأله معاوية: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز، قال: وما الإيجاز؟ قال: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ.
فقال له معاوية: أو كذلك تقول يا صحار؟ قال صحار: أقلني يا أمير المؤمنين، ألًا تبطئ ولا تخطئ”.
من أئمة الإباضِيَّة الأوائل الذين عاصروا الإمام جابر بن زيد وعاصر الحجاج، يقول أبو سفيان محبوب” أنَّه عاش بعد الحجاج، ولَمَّا صليت الجمعة لوقتها قال صحار: “الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا، لو كانت الجمعة بخراسان لكانت أهلًا أن تؤدى”.
ولصحار محاورات مع القدرية، إذ كان يقول لتلاميذه: “كلموهم في العلم فإن أقروا به نقضوا أقوالهم، وإن أنكروه كفروا”.
أورد له الفقهاء جملة من الآثار الفقهية والآراء العقدية وعدوه من شيوخ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي.
سكن البصرة وتُوفِّيَ بها نهاية القرن الأول الهجريِّ.